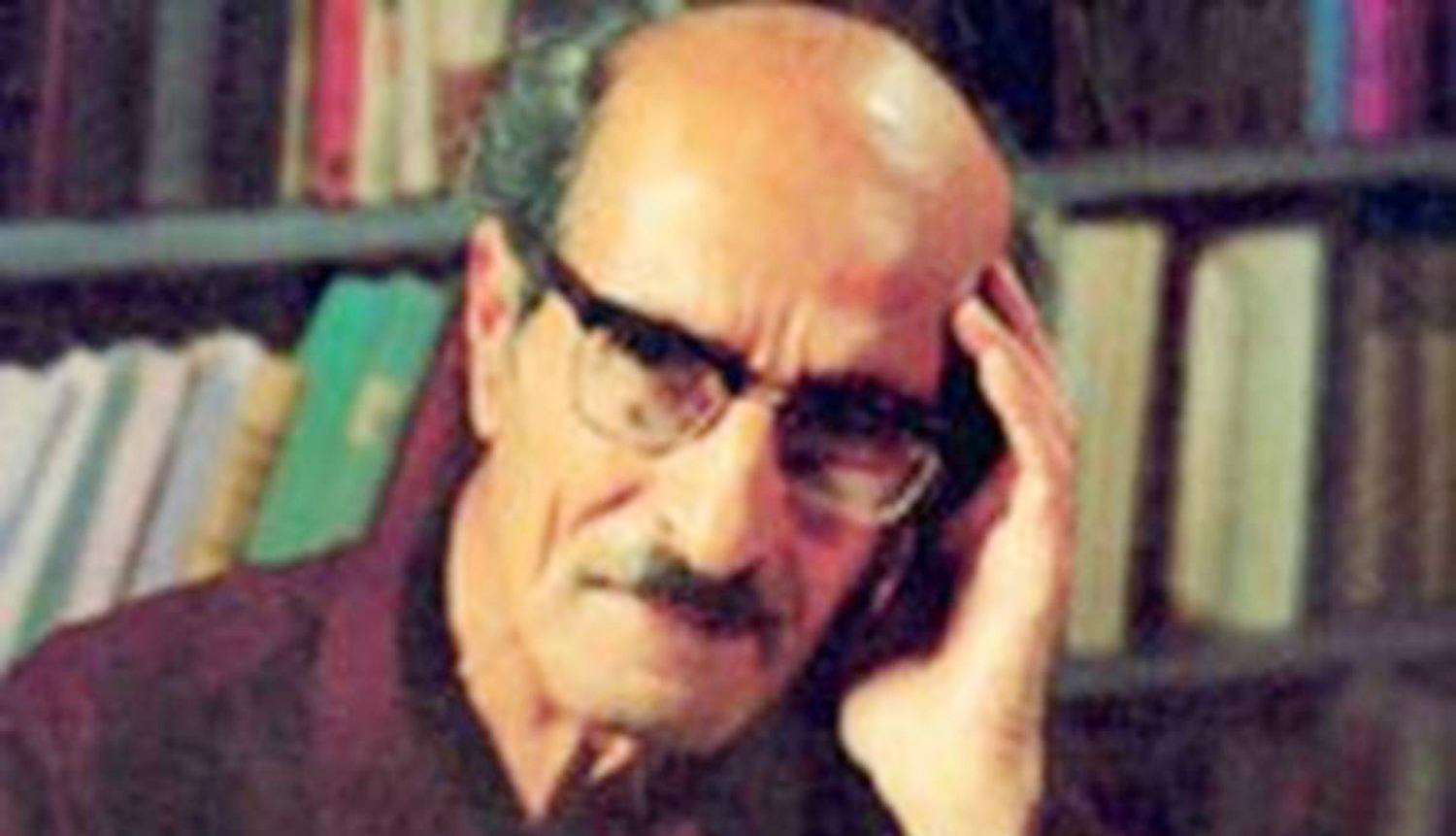
شوقي بزيع
لم أجد ضمن هذه السلسلة من المقالات التي تتناول الجانب العاطفي من حياة المبدعين، شخصية مثيرة للحيرة والالتباس كما هي حال الكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة. وهي حيرة لا تولدها علاقة «ناسك الشخروب» بالمرأة والحب فحسب، بل تنسحب على مواقفه من الجسد والروح، الأثرة والإيثار، الأنانية والغيرية، وغير ذلك من الثنائيات المتعارضة. لا بل أي تأمل عميق في سيرة الكاتب الحياتية، والعاطفية على وجه الخصوص، لا بد من أن يدفعنا إلى الاستنتاج أننا إزاء شخصية «مأزقية» ومشرعة على نوع من المفارقات، شبيهة بتلك التي جعلها سورين كيركغارد أحد المحاور الرئيسية لفلسفته وأعماله.
قد لا يجد قارئ نعيمة أي غضاضة في إشارة الكاتب، المولود في بسكنتا عام 1989، إلى تفوقه الدراسي الذي أوصله، وهو المسيحي الأورثوذكسي، إلى المدرسة الروسية في حيفا، ثم إلى بولتافا الأوكرانية ليكمل دراساته العليا في أحد معاهدها. وإذا كان بالأمر الطبيعي أن يؤكد نعيمة سعيه إلى التفوق عبر قوله: «لقد كانت تسعفني على التحصيل نزعة عنيفة إلى التفوق، فما كنت أطيق أن يكون في صفي من هم أكثر حظوة مني في عين المعلم»، إلا إن ما تتعذر استساغته هو نزوعه اللاحق إلى التباهي والاعتداد النرجسي بالذات. فهو يسرد في كتابه «سبعون» شهادات متنوعة بعث بها إليه قراء كثر مفتونون به وبكتاباته، كقول أحدهم إن «حبي لك يفوق حبي لأي كائن مهما كان»، وقول إحداهن: «وددت لو طويت الأرض تحت قدمي فأكون في حضرتك»، ووصف مؤسسة نشر هندية لكتاب «مرداد» بأنه «كتاب الساعة، بل كتاب الجيل، بل كتاب الأبدية».
كما يستشهد نعيمة لإثبات تفوقه بقول مواطنه رشيد أيوب: «أشهد من على السطوح بأن ميخائيل نعيمة هو الذي علمنا الشعر». ولا يتوانى عن الاستعانة بالعقاد لإثبات تفوقه على صاحب «العواصف»، حيث يسر له صديق له: «أريد أن أقول لك بالسر، إن العقاد قال لي إنه يرى فيك نبوغاً على جميع إخوانك، وعلى جبران أيضاً»، دون أن يأخذ في الاعتبار أن ما قاله العقاد قد يكون متصلاً بالتنافس الحاد بينه وبين جبران على قلب مي زيادة.
أما في الجانب العاطفي، فالواضح أن نزوع نعيمة الطهراني وخوفه من فكرة الخطيئة، قد غذتهما في داخله نشأته الريفية المحافظة، ثم رسختهما المؤسسات التعليمية المختلفة التي أولت اهتمامها الجمّ للتنشئة الأخلاقية والتعاليم اللاهوتية الأرثوذكسية. فنعيمة الذي التحق بالمدرسة الروسية في حيفا يصف حياته هناك بأنها كانت أشبه «بحياة الرهبان في الدير»، مشيراً إلى أن كثيراً من الطلبة قد طردوا من المدرسة بسبب تورطهم في علاقات مشبوهة. وهو إذ يرى في الزواج، رغم نأيه اللاحق عنه، الحل الأفضل لردع الخطيئة وإطفاء نار الغرائز الشهوانية، فهو لا يؤثر العفة المفروضة من قبل المجتمع وقوانينه وأعرافه، بل العفة الطوعية التي يفرضها الفرد على نفسه، مضيفاً: «لقد عانيت في كبح عاطفتي الجنسية الشيء الكثير، ولم أستسلم لها إلا في فترات من حياتي سأذكرها في حينها».
وإذ تأخرت معرفة نعيمة بالنساء بسبب مكابداته النفسية والروحية المرهقة، فإن احتكاكه الفعلي بالنساء قد حدث من خلال المرأة الأوكرانية المتزوجة «فاريا»، التي عرفه بها عام 1908 شقيقها إليوشا. وإذ يلح الكاتب على أنه حاول ما بوسعه الإشاحة بسمعه عن نداء المعصية، إلا إن البورتريه الذي قدمه لفاريا، ذات العينين الزرقاوين الواسعتين والبشرة الناعمة والشعر الكستنائي، فضلاً عن وضعنا نحن القراء في صورة محاولاتها المضنية لإغوائه، أظهرا حرصه الشديد على تقديم ما حدث بين الطرفين بوصفه نسخة جديدة عما حدث بين يوسف وزليخة، مع فارق أساسي تمثل في أن النبي قد حظي ببرهان ربه الذي نجاه من المعصية، فيما صاحب «الغربال» لم يحظ بمثل هذا البرهان.
ومع أن نعيمة لم يرفع راية استسلامه بسرعة للمرأة المتزوجة من رجل ضعيف الشخصية وبسيط إلى حد السذاجة، إلا إنه لا يلبث أن يشير في يومياته إلى الصراع الناشب في داخله بين الوحش الشهواني الذي استيقظ للتو، وبين صورته في عين نفسه وعيون زملائه الطلبة، الذين علقوا على لوحة المعهد رسماً يمثله وهو يقف أمام مومس مشهورة ليرشدها إلى طريق التوبة والعفة، ثم كتبوا تحت اللوحة العبارة التالية: «لقد أضعنا رفيقاً، ولكننا وجدنا نبياً». إلا إن ما ضاعف من وضعه المأزقي، هو ملاحقة فاريا له في حركاته وسكناته، واعترافها الصريح بأنها منذ التقت به لم يعرف قلبها الهدوء. وهي إذ تدرك حجم الصراع الذي يدور في داخله بين العفة والإثم، تحاول أن تكسب وده عن طريق إشعاره بأنها تشاطره المعاناة نفسها، بما جعلها تسقط فريسة المرض والآلام المبرحة، دون أن تنسى اتهامه بقسوة القلب، وبالانشغال عنها بأمور أخرى لا قبل لها بمعرفتها.
وكما يظهر من سياق السيرة، فإن دفاعات الشاب المتمنع لم تلبث أن سقطت أخيراً أمام إصرار فاريا على التشبث به، وصولاً إلى استعدادها الحاسم للذهاب معه إلى لبنان كما إلى نهاية العالم. وحين تأكد له أن إليوشا، شقيق فاريا، وزوجها كوتيا، كانا مطلعين على طبيعة العلاقة وتفاصيلها، كتب نعيمة يقول: «وهكذا استسلمت. أو قل هكذا خدّرت ضميري الحي لأهوّن عليه الاستسلام للبهيمة في داخلي. والغريب أن تنبت لي في أميركا بعد سنين، حالتان مماثلتان فأخرج منهما بعين النتيجة».
ورغم التوطد التدريجي للعلاقة بين نعيمة وفاريا، فإنه ظل متردداً في الاستجابة لإلحاحها اليومي على فكرة الزواج، بسبب شعوره الممض بالذنب اتجاه كوتيا المسكين. ومع قيامها المفاجئ بمحاولة الانتحار، رضي بالزواج منها شرط التحاق زوجها بأحد الأديرة المعروفة. إلا إن رفض الكنيسة هذا الأمر، حرر نعيمة من مأزقه الصعب، ليعود وحيداً إلى لبنان. أما آخر فصول هذه العلاقة المعقدة فقد تمثلت في الرسالة المؤثرة التي بعثت بها فاريا إلى الحبيب اللبناني، الذي لم تتح له قراءة الرسالة إلا بعد مغادرته الوطن الأم باتجاه المهجر الأميركي.
وإذا كانت علاقات نعيمة بالنساء لم تقتصر على فاريا وحدها، فإن اللافت في هذا السياق هو إلحاحه المستمر على إظهار نفسه بمظهر الساحر الصدود لكل من شاءت الظروف أن يلتقي بهن. لذلك فهو لا يجد غضاضة في القول: «لقد هامت بي أكثر من فتاة ذلك الصيف. إلا أنني لم أفتح قلبي ولا استسلمت لإغراء أية واحدة منهن. ولو شئت أن أمثل دور دون جوان لمثلته بسهولة». ثم يتابع متسائلاً: «ماذا أصنع بقلبي الذي ترتمي عليه القلوب وهو لم يجد بعد قلباً يرتمي عليه؟ إنه يريد أن يحب، أن يذوب في الحب، ولكنه لم يجد ضالته، وسيجدها يوماً ما». ويتحدث نعيمة خلال إقامته في فرنسا عن الفتاة الأرستقراطية مادلين التي ظلت تتحين الفرص لاصطياده في حديقة الجامعة، والتي قاوم إغواءها حتى اللحظة الأخيرة. كما يتحدث خلال إقامته الأميركية عن علاقة عاطفية بامرأة متزوجة دعاها بيلّا، معترفاً بأنه أحبها من صميم قلبه، وملقياً عن كاهله عقد الذنب، باعتبار أنها لم تحمل لزوجها السكير سوى مشاعر الكراهية والاشمئزاز.
ثم لا يلبث نعيمة أن يحدثنا عن غرام جديد مع «العاصفة الهوجاء» التي دعاها «نيونيا»، صديقة أحد الرسامين الطليان، والباحثة عن قوت من اللحم والدم والكلمات والنظرات، لا قبل لأحد سواه بتوفيره لها، على حد قوله الحرفي. وهي علاقة استمرت بين عامي 1929 و1932، إضافة إلى علاقات سريعة أخرى، كعلاقته بهيلدا التي طلبت أن يمضي سهرة معها، ليضيف قائلاً: «ولم أشأ أن أكسر خاطرها فقبلتها قبلة عفيفة على جبينها»، وعلاقته المماثلة برئيسة تحرير مجلة أميركية، وبرسامة معروفة التقى بها ليلة وفاة جبران، وأخريات غيرهن.
وإذا لم يكن لنا أخيراً أن نأخذ على نعيمة قراره النهائي بالعزوف عن الزواج، وهو الذي يعترف بوضوح تام: «تبين لي من علاقاتي مع النساء أنني لم أولد لأكون بعلاً لامرأة، وأباً لعدد من البنات والبنين، فعملي في حياتي هو أكثر من تحديد النسل، وهذا العمل لا يطيق لصاحبه أن يتزوج ضرة عليه»، إلا إن من حقنا أن نتساءل في المقابل عن الأسباب التي جعلت نعيمة يسوغ لنفسه ما حرّمه على جبران، وهو الذي نعت صاحب «النبي» بأنه نهش لحم النساء اللاتي تعلقن به، وبأنه كان يدعو النساء إلى فراشه لا إلى قلبه، ومن حقنا أن نتساءل في الوقت ذاته عما إذا كانت الصدف وحدها هي التي جعلت علاقاته العاطفية محصورة بنساء متزوجات، أم إن الأمر متصل بدوافع سيكولوجية عميقة، من بينها إثبات تفوقه على الآخرين، ومنازلتهم فوق ساحاتهم الخاصة وفي عقر أسرّتهم الزوجية؟









